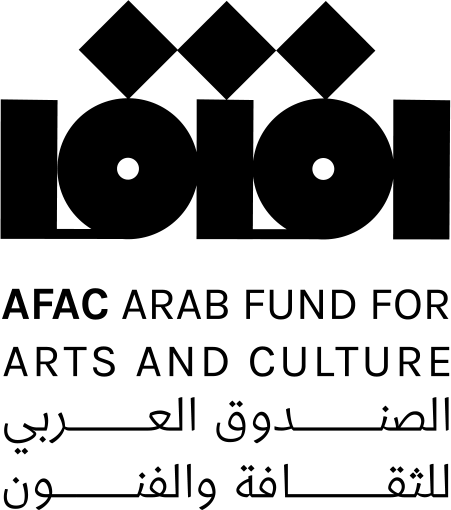أهميّة الرقص في تحرّره المطلق
فيما يلي سنُسلّط الضوء على مُصمّم الرقص الفرنسي الجزائري طارق أيت مدّور وعرضه الأدائي "يقاوم" الذي عُرض للمرة الأولى في تشرين الأول الماضي.
قبل أن نلِج صُلب الموضوع، أخبرنا عنك أولاً. لقد اكتشفت الرقص بطريقة فريدة، هل لك أن تشرحها؟
بالفعل كانت صلتي الأولى بالرقص فريدةً حقاً، خصوصاً وقد اكتشفته في مرحلة متأخرة نسبياً... بدأت ممارسة رياضة الجودو في سن مبكرة (8-9 سنوات). وانتظمت في التمرين لعشر سنوات، حتى صرت أهواها. بالرجوع إلى تلك اللحظة، اكتشفت إن الأمر كان أكبر من مجرد رياضة، كانت بالأحرى فلسفة. كانت الجودو رياضة حكيمة وفلسفية. القوة المتوّلدة عن اللعب والتلاحم الجسدي مع الآخر تُفضي بك إلى احترام النظام؛ لقد تعلمت الكثير جرّاء ذلك.
بين السادسة عشرة والسابعة عشرة من العمر، توقّفت عن ممارسة الجودو وبدأت الانتظام في صفوف الجامعة، والتأهل لنيل درجة البكالوريوس في التاريخ. في الجامعة، كانت هناك المدرسة الوطنية للرقص في كريتاي، والتي كانت تُقدّم نهار الجمعة من كل أسبوع صفاً دراسياً للرقص يمتد لساعة ونصف الساعة تحت إشراف معلمة مؤهلة. ذات مرة ذهبت لهذا الصف بصحبة أحد الأصدقاء، وهكذا بدأ كل شيء. أخبرتني المعلمة إنها ستساعدني بكل ما في مقدورها لتطوير مسيرتي المهنية في الرقص. وكان هذا كل ما في الأمر، قصةٌ مدهشةٌ بحق. أخبرتها حينذاك "أبلغ العشرين من العمر، ويبدو لي ذلك متأخراً، وسيتطلّب الأمر الكثير من المال، ولن يلقى ترحيب الأهل. أظن ذلك مستحيلاً."
واقع الحال لم يكن هناك من مستحيل. تقدّمت للأكاديمية العالمية للرقص بباريس، تلك المدرسة الفنيّة الرفيعة، وعلى مدار أسبوع خضعت لاختبارات أداء شملت إلى جوار الرقص، المسرح والموسيقى كذلك. لم أُقبل وحسب، بل حصلت على منحةٍ دراسيةٍ سمحت لي بالانتظام في الدراسة دون رسوم. كانت تلك نقطة التحوّل في مسيرتي المهنية، بل وحياتي أيضاً. الآن أمتهن الرقص منذ عشر سنوات، وهكذا بدأت قصتي. وهي قصةٌ غير معقولة، يعود الفضل فيها إلى رياضة الجودو، التي إلى اليوم تساعدني كثيراً في الرقص والتفكّر الروحاني وفي مقاربتي للأشياء، وفي فهمي لطاقة جسدي وفي علاقته مع الأجساد الأخرى؛ عندما أمسك جسداً أنثوياً وأنا أرقص، وعندما أعمل على فنيّات التحكم، وغيرها. علّمتني الجودو كثيراً.
هي رحلةٌ غير تقليدية، إلا أنني لا أعتقد أن في الأمر صدفة، فكل شيء يسير على السمت ذاته بنهاية الأمر. كان المقابل باهظاً رغم ذلك. خسرت علاقتي مع أهلي الذين رفضوا خياري. كانت عائلتي تعاني من عدم الاستقرار. انفصل أبواي وأنا في الخامسة عشر من العمر. وعندما بدأت الرقص في عمر العشرين، قوبل ذلك بالرفض التام، كنوع من الإنكار، حتى بين أخوتي وأخواتي. ما أفضى إلى قطيعةٍ مع بعض أفراد عائلتي المقربين إلى اليوم.
أنت فرنسي جزائري وتعيش بباريس. كيف تحافظ على صلتك بالمشهد الفنّي الجزائري؟
وُلدت بالجزائر لأبوين من القبائل، وعشت هناك حتى الخامسة أو السادسة من العمر. بعدها قرر أبواي الانتقال إلى فرنسا، مباشرةً إلى باريس، حيث يمكننا الاستقرار ومتابعة الدرس. عقب المشاكل بين أبويّ لم أعد إلى الجزائر لعشر سنوات. إلا أنه وبعد طلاقهما، زرت الجزائر وأنا في السادسة عشرة بمناسبة عرس أختي. سمح لي ذلك باستعادة التواصل مع جذوري وثقافتي، والتي تؤثر فيّ بشكل أساسي إلى اليوم. أعود إلى زيارة الجزائر مرةً كلّ عامين، للإبقاء على أُصُر الصلة مع ثقافتي التي هي جزءٌ لا يتجزأ مني يلهمني كثيراً وأعتز به.
لا أعتبر نفسي جزائرياً أو فرنسياً فقط، فشخصيتي هي مزيج الاثنين معاً. من السهل القول أني فرنسي بالنظر لأنني أعيش بباريس منذ عشرين عاماً. إلا أنني أبقي على صلتي بتراثي العربي الشرقي في كل مرةٍ أزور بلدي واستلهم تأثيره على فنّي الذي أفخر به وهو يشقّ طريقاً بين الشرق والغرب. أودّ أن أرسّخ عملي في فرنسا، فهي حيث أعيش وهي المكان الذي يوفّر لي الإمكانات والأدوات اللازمة لذلك. وعندما يتحقّق هذا، سيسعدني أن أسافر عبر العالم العربي لمشاركة عملي، فالعالم العربي هو مصدر إلهامي.
بالحديث عن الإلهام، في عملك "يقاوم" تُسائِل العلاقة بين نفسك والآخر، كما الرغبة في التحرّر والفِكاك من أسر نظرة الآخر لك. ما الذي ألهمك لهذا العمل؟
بشكلٍ عام، أجد الإلهام في كل شيء؛ في الموسيقى وفي الكتب وفي مشاهدة الأخبار على التلفاز وفي لقاء عابر في المترو وفي مراقبة النجوم، فالأفلاك تثير إلهامي كثيراً... بالإضافة إلى تراثنا الثقافي والاجتماعي والتاريخي والديموغرافي والجغرافي. عندما بدأت كتابة "يقاوم"، كان مصدر إلهامي هو ذات السؤال الإنساني عن ذلك الذي يجعلنا مختلفين عن الآخرين. وحقيقة الأمر ليس من ثمّة أسباب كُثر تُفرّقنا مقارنةً بالأسباب التي تُوحّدنا. رغبت في كتابة "يقاوم" كنداء استغاثة أو إنذار طوارئ، كشهقةٍ، كشيء يعتمل قبل أن ينفجر طلباً للوحدة. "يقاوم" هو بالأساس رسالة حب. أردت أن أعيد تعريف مفهوم ذلك الذي يُفرّقنا لجهة النوع والجنس والجندر واللون وغيرها. هناك أيضاً إحالة إلى التراث الإغريقي تظهر في الأردية البيضاء المُوّحدة لكل المؤدين. لم تكن تلك تفصيلةٌ عارضة.
حركاتٌ مُفعمةٌ بالتوتّر، انفعاليةٌ لكنها منسابة. إيماءاتٌ متكرّرة وحركاتٌ مخلخلة تبلغ مداها عند ذروةٍ نهائيةٍ من الحسيّة والتناغم. في "يقاوم" يصلنا انطباع أن كل مؤدٍ من المؤدين الثمانية يتحرّك بشكلٍ مستقل، إلا أنه يُشكّل كلاً متسقاً مع البقية. كما لو كانت أجسامهم تريد إيصال رسالةٍ ما، مضطربةٌ وشغوفةٌ في آن، في لغةٍ جسديةٍ تتساءل. أخبرنا المزيد.
واقع الأمر أن بناء العرض الأدائي في "يقاوم" ينطوي على أسس الحب والأمل وملامح المقاومة. لإنجاز ذلك، كان لابد عليّ أن أدعم زملائي وأرشدهم في عمليةٍ تواصلية وجماعية. هم يتحركون ويتكلمون باسم شخصٍ وقضية واحدة.
بالرغم من ذلك، طلبت منهم أيضاً ألا ينسوا أنفسهم. فالوحدة هي ما يخلق المجموعة، وكان من المهم جداً بالنسبة لي أن يتمكّن كل منهم من التكلم والوجود بذاته. كان الحديث عن الحب والأمل ورسائل الوحدة والمقاومة ليصبح هشاً ومتناقضاً ومُراءٍ إن طلبت من المؤدين أن يتناسوا ذواتهم. فالعمل يتناول المجموعة والجماعية ويتناول أيضاً الفرد والفردانية. المؤدون مختلفون، ولكل منهم ذاته وقد جَهَدت لإظهار هذا الفرق؛ لإظهار تلك الروح الفردانية التي تُميّز كل منهم، كي أتمكن لاحقاً من صياغتها والتعبير عنها ضمن المجموع. في نظري، هذا أمر مهم جداً، ويحمل رسالة تعكس بشكل في غاية البساطة واحداً من نواقص مجتمعنا اليوم، حيث لا يملك الجميع ذات الفرص للترقّي أو لا يقعون جميعاً على ذات المسافة من طائلة العقاب القانوني. لا نحظى بالفرص ذاتها على ظهر هذا الكوكب، ناهيك عن هذا البلد أو ذاك. لم نُولد سواسية. وفي "يقاوم" نجد رؤية طوباوية، ومحاولة لاستعادة البساطة الإنسانية وروح الأخوة والتعاضد.
لاقى "يقاوم" نجاحاً عندما قُدّم على مسرح "نوفير" في فرنسا في 26 تشرين الأول 2019. هل كانت ردود الأفعال وانطباعات الجمهور الأولى على العمل ضمن توقعاتك؟ وهل تمكنت من إشراك مشاهدين من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن فئات أخرى كما كان مخططاً؟
دعني أجيب عن سؤالك الأول أولاً: نعم، الفيديو الذي يمثل روح العمل تمت مشاركته على منصات التواصل الاجتماعي وحاز ملايين المشاهدات. وهذا أمر غير اعتيادي بالنسبة لفيديوهات الرقص المعاصر. وهذا هو ما دفعنا لتصميم القطعة الفنيّة الراقصة نفسها، والتي تمكّنا من الانتهاء منها وتقديمها للجمهور في 26 تشرين الأول 2019 على مسرح "نوفير". بعد تقديم العرض فاق استقبال الجمهور توقعاتنا. كان الجو مفعماً بالمشاعر والعواطف بين أفراد فريق العمل، وهو ما وصل صداه للجمهور. بقي الكل ملتصقاً بكرسيه في صمت مهيب. وبعد ساعة من العرض، اشتعلت الصالة بالتصفيق الحار. وبناءاً عليه دعتنا إدارة المسرح لأداء عرضي الجديد بعنوان "الحفلة" في العام المقبل في 12 آذار.
بالعودة لسؤالك الثاني بخصوص الجمهور، نعمل منذ فترة مع المؤسسة المسؤولة عن دور إعاشة المسنين على بعض المشروعات المتعلقة بالتواصل، كما عملنا معهم مسبقاً حول تيمات المقاومة في كل ليون وبياريتس بجنوب فرنسا. كذلك عملنا مع بعض مدارس الرقص التي تستقبل راقصين من كافة الفئات دون تمييز ومع معالجين فنيين يساعدون راقصين مُتوحّدين أو مُتعايشين مع متلازمة داون... وشعرنا أنه من المنطقي، بل واللازم، أن ينعكس أثر هذه الخبرات المختلفة على عملنا الذي يجب أيضاً أن يكون متاحاً لجمهور أوسع خصوصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة. لذا ليلة العرض كانت الدعوة مفتوحةً للجميع كباراً وصغاراً، كان الكل مدعواً.
للموسيقى دورٌ محوري في عرضك الأدائي. المقطوعات الموسيقية قويةٌ وشديدة الاختلاف على تكرارها وتعمل كفاصل انتقالي بين المشاهد، إلا أنها تترك شعوراً من عدم الارتياح لدى المشاهد، وهو أمرٌ مقصودٌ على الأرجح. هل لك أن تشرح لنا هذه الاستراتيجية الموسيقية؟
ارتباطي بالموسيقى مُتجذّر ويتخطّى العمل الأخير "يقاوم". هويت الموسيقى منذ الطفولة. وإلى اليوم يلعب سماعي إلى الموسيقى دوراً أساسياً في تصميمي للرقصات. أثناء العمل على "يقاوم" قلت لنفسي أريد شيئاً مختلفاً. كان لدي قاعدة أنطلق منها، فقد عملت في ضوء موسيقا فيفالدي الكلاسيكية أثناء تطوير الفيديو الخاص بالعرض. هي موسيقا مُتشنجّة وانفعالية. إلا أني أحسست بنقص ما، فلا يمكنني أن أصمم عملاً راقصاً مدته ساعة على وقع مقطوعة كلاسيكية لأنطونيو فيفالدي. أردت شيئاً جديداً، شيئاً خلاقاً. كما أن اللمسة العربية كانت غائبةً بوضوح. وهنا جاء دور جاسر حاج يوسف. وهو صديقٌ وفنّانٌ موهوب ويعود له الفضل في موسيقا "يقاوم". كانت موسيقى جاسر بالتضافر مع موسيقا فيفالدي خليطاً مثالياً يُوفّق موسيقا الباروك مع الموسيقى العربية، ما يُسهم أيضاً في إيصال الرسالة ذاتها عن روح الأخوة وتجاوز الحدود.
ومن الحقيقي أن المقطوعات الموسيقية متشابهة رغم اختلافها، وتفصل بين المشاهد أو اللوحات الراقصة. فالعرض الأدائي هو بمثابة كلٌ متّصل لمدّة ساعة، ينقسم لأجزاء أربعة تُمثّل فصول السنة. بشكلٍ مرتّب، نرقص صيفاً، ثم خريفاً يليه شتاءٌ يليه ربيع. الرقصة هي تصوّرٌ مُعجّل للحياة بينما تُطوى صفحاتها على وقع فصول السنة.
ماذا الذي يميّز مشهد الرقص المعاصر في المنطقة العربية برأيك؟
أهم ما يميّز مشهد الرقص المعاصر في المنطقة العربية هي حيويته. يعيش العالم العربي حالياً حالة طوارئ مستمرّة وحالة ثورة مستمرة تؤثّر على الثقافة والإبداع الفني فيها. ترتبط المنطقة العربية ارتباطاً وثيقاً بالموسيقى والرقص. وهذا الرابط هو ما يؤمن استمرارية الفنون. الرقص المعاصر في المنطقة العربية أشبه بشجرة نخيل في الصحراء؛ فهي تبدو معزولة وضعيفة، لكن خلفها يمتد بستان نخيل لا متناهٍ. شغف الفنانين والفنانات العرب وعزيمتهم سيعيدان للرقص المكانة التي يستحقّها، التحرّر المطلق.