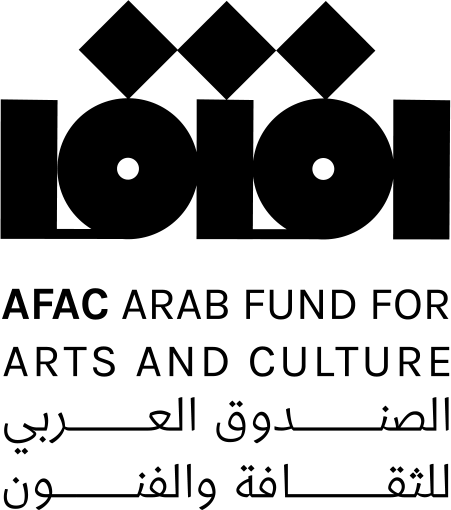يستكشف الفيلم الروائي السوداني "وداعاً جوليا" السياقات الاجتماعية للانقسام بين شمال السودان وجنوبه من خلال قصة امرأتين.
قابلنا المخرج محمد كردفاني والمنتج أمجد أبو العلا للغوص في خصائص الفيلم والتقدير الدولي الذي ناله، وما يعني ذلك بالنسبة لمستقبل السينما السودانية.
عن المشروع
محملة بالذنب لطمسها جريمة القتل، تسعى منى، المغنية السودانية الشمالية المتقاعدة والتي تعيش في زواج متوتر، للتكفير عن خطاياها باستضافتها جوليا، أرملة المقتول الجنوبية، وابنها دانيال في منزلها. عاجزة عن الاعتراف بجريمتها أمام جوليا، تقرر منى ترك الماضي والتكيّف مع الوضع الجديد، دون أن تدرك أن واقع الاضطرابات في البلاد قد يجد طريقه إلى منزلها، ويضعها في مواجهة ذنوبها.
حوار مع المخرج محمد كردفاني، أجرته رنا قبيسي عبر زووم
رنا قبيسي: ما هو السبب وراء اختيارك التطرق إلى الصراع في السودان، الذي أدى في النهاية إلى انفصال جنوب السودان، من خلال العلاقة التخيلية بين امرأتين في "وداعاً جوليا"؟ وما الذي سمح لك التخيّل بتحقيقه في استعراض الوضع في السودان؟
محمد كردفاني: اخترت الروائي لأن هناك العديد من التقارير الإخبارية والوثائقيات التي تناولت هذه القضية، لكنها غالباً ما تسلّط الضوء على الجانب السياسي. أعتقد أن العنصر الاجتماعي في قضية انفصال جنوب السودان أمر شديد الأهمية، وأردت كذلك أن ألقي نظرة حميمية على كيفية تأثير التفاصيل الصغيرة على الأحداث الكبرى. لذلك اخترت تصوير القصة بأكملها داخل منزل يمكن لهذا المنزل الواحد أن يظهر لك حجم تأثير السلوك الفردي، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال التخيّل.
قبيسي: "وداعاً جوليا" فيلم يحمل في طياته طبقات عدة، فهناك العلاقة المعقدة بين منى وجوليا، والتنقّل بين الشخصي/الخاص والاجتماعي/السياسي. كيف تمكنت من تحقيق هذا الكم من التعقيدات والطبقات؟ هل يمكن أن تحكي لنا عن عملية كتابة الفيلم؟
كردفاني: استغرقت الكتابة وقتاً طويلاً، وتم تطويرها تدريجياً كل بضعة أشهر. في المراحل الأولى، كانت القصة ذات حبكة بسيطة جداً. أدركت بعد المسودة الأولى أن الشخصيات كانت شديدة السطحية، لأنها لم تكن سوى مجرد حبكة. بدأت بعدها بدمج تجاربي الشخصية في شخصيات القصة، واخترت مراحل مختلفة من حياتي لأنني أعتقد أني تغيرت كثيراً على مدار 20 عاماً. من 20 عاماً، كان فيّ جزء كبير من أكرم، زوج منى، واستمر ذلك لخمس أو ست سنوات. بدأت بعدها بتبني أفكاراً أكثر تقدمية. وكان في داخلي كذلك بعض من منى، تحديداً عندما بدأت تتبنى أفكاراً تقدمية، ولم أكن متأكداً حينها كيف أتصرف. كنت أخطو خطوتين إلى الأمام وخطوة إلى الوراء، ولم أكن قادراً على مشاركة أفكاري مع الآخرين من حولي، والذين كانوا محافظين إلى حد ما. لذا كنت أعيش نوعاً من الحياة المزدوجة، بمعايير مزدوجة. ومن هنا جاءت فكرة شخصية منى. يشابه سعي منى وراء الغناء سعيي أنا وراء الفن. كنت أعمل كمهندس طيران منذ 16 عاماً، ولما بدأت في كتابة "وداعاً جوليا"، قررت التحوّل بالكامل إلى صناعة الأفلام. كان ذلك قراراً صعباً لأن صناعة الأفلام في مجتمعنا مهنة غير مُحترمة، إلى جانب العديد من الالتزامات المالية. لذا كان الأمر شديد الصعوبة، ولكنه ما كافحت من أجله، وأردت أن أصب بعضاً من تجربتي تلك في الكتابة. أعتقد أن الجانب الشخصي والسياسي كلاهما موجود بداخل المرء، وينعكسان بدورهما في السيناريو.
قبيسي: في الفيلم، تغني منى أغنية للمطرب السوداني الشهير الراحل سيد خليفة في كنيسة، بتركيب يتضمن لهجات إفريقية. كيف مثلت الاختلافات في الفيلم ولماذا كان هذا مهماً؟
كردفاني: جنوب السودان هي دولة سيادية الآن ولم تعد جزءاً من السودان. لكن الفيلم يعتبر نداءً للتصالح مع مناطق أخرى في السودان تواجه نفس التحديات التي يتناولها الفيلم. "وداعاً جوليا" كان يهدف إلى أن يكون صيحة إنذار قبل اندلاع الحرب، لأنني وغيري كثيرين كنا نعلم أننا على مشارفها.
أما بالنسبة للاختلافات، أردت أن أظهرها كشيء ينبغي الاحتفاء به، عوضاً عن كونها من دواعي الانقسام بيننا، وقد عبّرت عن ذلك بطرق عدة في الفيلم، من خلال اختيارات الملابس أو في الفن أو ديكور المنزل، نرى أن أكرم ومنى يحملان طابعاً عربياً إسلامياً واضحاً، وفي المقابل، تعكس غرفة جوليا بالكروشيه والألوان طابعاً إفريقياً. وحتى في الملابس، تمثل فساتين منى فترة عام 2005 حين كان الإسلاميون في ذروة سلطتهم ولم يكن يُسمح للنساء بالخروج من المنزل دون حجاب، وكان عليهن ارتداء أكمام تحت الفساتين. من ناحية أخرى، تظل جوليا ترتدي ما يمثل جنوب السودان. يمكن للمشاهد أن يرى بوضوح الاختلافات في الهوية. تتعايش تلك الاختلافات بنفس الانسجام التي تتعايش به أنواع الموسيقى في الفيلم، فلدينا موسيقى من الجنوب ومن الشمال، والأغنية التي تغنيها منى في الكنيسة هي في الواقع دمج للاثنين. الفنان الأصلي، سيد خليفة، لم يغنيها مع جوقة كنيسة، إلا أننا قمنا بذلك في الفيلم وكانت النتيجة رائعة.
قبيسي: كيف قمت باختيار طاقم الممثلين؟ وهل كان لديك مخاوف بشأن التمثيل الشمالي-الجنوبي؟
كردفاني: هناك ممثلون وهناك شخصيات، والقصة تأتي في المقام الأول، ولكن بالطبع، كانت هناك بعض النقاشات حول إمكانية اختيار ممثل ليس من جنوب السودان لأداء دور شخصية جنوبية، نظراً لندرة الممثلين الجنوبيين، خاصة في الخرطوم. ومع ذلك، كنت شديد الحرص على العثور على طاقم ممثلين من جنوب السودان، وبالفعل نجحت في ذلك. أعلنت عن تجارب الأداء وأجريت العديد منها للدورين الرئيسيّين، ولكني لم أجد ما كنت أبحث عنه. ثم وجدت إيمان يوسف، التي تلعب دور منى، بالصدفة على وسائل التواصل الإجتماعي. كان هناك شخص يبث فيديو مباشر لها وهي تغني في مقهى. ووجدت سيران، التي تلعب دور جوليا، كذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، في مقابلة لها بصفتها ملكة جمال جنوب السودان. كلتاهما أذهلتاني. تواصلت معهما ودعوتهما لعمل اختبار أداء، وحصلتا على الدور من أول تجربة. بالنسبة للطاقم، العديد من أعضائه كانوا من جنوب السودان، خاصة للوظائف الاستشارية. أردت تمثيلاً حقيقياً لجنوب السودان. لم أرد أن يبدو الأمر سطحياً. لذا، استشرت خبراء في التعاليم الكاثوليكية في ثقافة جنوب السودان، واستعنت كذلك بمساعدين لجلب الممثلين وولوج المجتمعات الجنوبية في الخرطوم. هذا مما أفخر به، فعندما قررت كتابة "وداعاً جوليا"، لم تكن لدي أية علاقات مقربة مع أي شخص من جنوب السودان، ولكن من خلال هذا الفيلم، أصبح لدي الآن العديد من الصداقات، صداقات ممتدة، وهذا يعني لي الكثير.
قبيسي: هل يمكنك أن تحدثنا عن الإشادة الدولية التي حصل عليها فيلم "وداعاً جوليا" وما يعنيه ذلك لصناعة السينما السودانية داخل البلاد وخارجها؟
كردفاني: أعتقد أنه عندما تكون بلادك في حرب، يصبح الكلام عن السينما جريمة بصورة ما، لأن هناك أشخاص على أرض الواقع يفقدون حياتهم الآن. لا أنكر أهمية السينما. يمكن أن نرى كيف أن "وداعاً جوليا" كان بمثابة بصيص أمل للشعب السوداني في أرجاء المنطقة وحتى أبعد من ذلك في أوروبا والولايات المتحدة. سارع السودانيون لمشاهدة فيلم من بلدهم. أعتقد أننا، بمحض الصدفة، تمكننا في الفيلم من التقاط الصورة الأخيرة للخرطوم قبل الحرب، ولامس ذلك قلوب الناس ومنحهم شيئاً من الأمل، حتى أثناء الحرب، بل وأعتقد أن ذلك يسري على زمن الحرب أكثر من أي وقت آخر. ولكن التفكير في مستقبل السينما بدون سلام في السودان هو شيء لا يمكن تحقيقه في الوقت الحالي ولا يبدو منطقياً.
حوار مع المنتج أمجد أبو العلا، أجرته رنا قبيسي عبر زووم:
رنا قبيسي: تتشاركان أنت ومحمد كردفاني في تطلعكما لسرد القصص السودانية. كيف التقيتما؟ وما الذي دفعكما إلى العمل معاً على هذا الفيلم؟
أمجد أبو العلا: التقيت بمحمد كردفاني قبل عشر سنوات في زيارتي للسودان عائداً من دبي، وكنت أزور السودان حينها عدة مرات في السنة. كنت أبحث عن صنّاع أفلام في بلد لا توجد به صناعة سينمائية. لم يكن هناك ورش عمل ولا مدرسة سينما ولا شيء. العثور على صانعي أفلام في السودان كان شبيهاً بالبحث عن كنز في جبل بعيد. ثم سمعت عن شخص يعمل كمهندس طيران ويستخدم مدخراته كل عام لصناعة فيلم قصير، صناعة فردية بقليل من المساعدة من هنا أو هناك. كان يقوم بتصوير المادة، ثم يحرّرها، ثم ينشرها على فيسبوك أو يوتيوب. عندما شاهدت أفلامه القصيرة، علمت أنه لم يكن يدرك أنه صانع أفلام وبإمكانه عرض أعماله في المهرجانات. تعرفين كيف تفرض علينا عائلاتنا مساراً مهنياً مثل الهندسة والطب. أعتقد أنه كان يحاول بأفلامه أن يقول لنفسه، "لا، أنا فنان"، وليس من أجل عرضها في المهرجانات. تواصلت معه وأصبحنا أصدقاء. بعد بضع سنوات، ساعدته في عمل فيلم قصير له، وبعدها أخبرني عن "وداعاً جوليا" بينما كنت أستعد للعمل على "ستموت في العشرين*". أراد أن يقوم بذلك بنفس الطريقة: عرض لشخص واحد، أو ربما ثلاثة على أقصى تقدير، بميزانية تتراوح بين 20 إلى 30 ألف دولار. قلت له، "لكن لماذا؟ هذا مشروع جاد"، وأجاب، "لا يوجد سينما الآن، نحن نعاني".
قلت له، "حسناً، دعنا ننتظر، دعني أرى ما الذي سيؤول إليه فيلمي "ستموت في العشرين" وسوف تكون معي خلال العمل على أي حال. إذا تمكّنا من تحقيق ذلك، سننتقل إلى العمل على "وداعاً جوليا".
ذلك ما حدث. دعوته ليكون معي في موقع التصوير، فقط ليلاحظ. خصصت له كرسي بجواري وكان معي لمدة ثلاثة أو أربعة أسابيع من التصوير. فور انتهاء التصوير، وعندما كنت أقوم بتحرير "ستموت في العشرين" في فرنسا، سافرت إليه لعمل أول مقترح لـ"وداعاً جوليا". في رأيي، تكوّنت بيننا رابطة كصنّاع أفلام يبحثون عن الأساطير. أعتقد أننا كنا في حاجة للعثور على بعضنا البعض والعمل معاً، جنباً إلى جنب مع صنّاع أفلام آخرين كانوا مشاركين بالفعل في "ستموت في العشرين"، وقد انضم عدد منهم للعمل على "وداعاً جوليا"، مثل رواد حبيقة ورنا عيد من لبنان وهبة عثمان من مصر، وقد عملوا معه مجدداً لأنهم تعرفوا عليه شخصياً خلال العمل على"ستموت في العشرين".
قبيسي: حصل فيلم "وداعاً جوليا" على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة "نظرة ما" من مهرجان كان السينمائي، وهو الفيلم السوداني الثاني الذي يتم تقديمه للترشّح لجائزة أوسكار، بعد فيلمك "ستموت في العشرين". هل تعتقد أن هذا إنجازاً هاماً في صناعة الأفلام السودانية، ويساهم في تشكيل صناعة سينمائية في السودان؟
أبو العلا: سؤال صعب ومؤلم جدًا. مؤلم لأنه لو كنت طرحت عليّ هذا السؤال العام الماضي، كنت سأقول: نعم، لقد حققنا تقدماً. كانت عملية صناعة فيلم "وداعاً جوليا" أقل مشقّة مما كانت عليه مع "ستموت في العشرين"، لذا يعتبر ذلك تقدماً. وجدنا أشخاصاً من السودان ليكونوا منتجين تنفيذيين للفيلم. بعد الثورة، أصبحت السودان جميلة إلى حد ما، رغم كل الظروف. بعد عام 2019، بدأت تتحوّل إلى بلد مدني ذي قوانين وحرّيات. على سبيل المثال، كيف تشكّلت لجنة الأوسكار السودانية؟ عندما أردنا تقديم "ستموت في العشرين" للأوسكار، كان يجب أن يتم ذلك على المستوى الوطني. لو كنا قمنا بذلك قبل الثورة، لم تكن الحكومة الإسلامية حينها لتوافق. ولكن بعد 2019، كان لدينا حكومة مدنية وليبرالية، شكلت لجنة وقامت بتعيين شخص ليكون على اتصال مع لجنة الأوسكار. بالنسبة لـ"وداعاً جوليا"، اجتمعت نفس اللجنة مرة أخرى وقدمت الفيلم للأوسكار. لحسن الحظ، قالت الأكاديمية إن اللجنة الخاصة ببلدنا صالحة لمدة ست سنوات. وإلا لما كان ذلك ممكنًا، لأن بلدنا لم يعد كما كان.
عودة إلى السؤال حول ما إذا كانت هذه الأفلام يمكن أن تساعد صناعة السينما في السودان: نعم. على الأقل، يمكن أن تعطي أملاً لصنّاع الأفلام الآخرين. أما على المستوى العملي، فهذا ليس ممكناً، لأنه لم يعد هناك بلد. ليس هناك مكان للتصوير. ليس لدينا حتى مدينة للعودة إليها. لا أستطيع أن آخذ رواد حبيقة من لبنان الآن وأذهب إلى السودان للتصوير. خلال الثورة، جاء رواد معي عندما كان الأمر كله مجرد احتجاجات في الشوارع، واستمتع بوجوده هناك. ولكن الآن، لا أستطيع أن أضعه أو نفسي في خطر. الأفلام السودانية التي نعمل عليها الآن ستكون مصوّرة بشكل أساسي خارج السودان.
قبيسي: بالنظر إلى الأوضاع الحالية في السودان الآن، ماذا تقول لمن يطمح في إنتاج وصناعة الأفلام هناك؟
أبو العلا: ما كنت سأقوله لهم عادة ليس هو ما سأقوله لهم الآن في ظل الحرب. شكّل حشد التمويل لفيلم "ستموت في العشرين" تحدياً كبيراً. وضعت آفاق ثقتها في "ستموت في العشرين" -كان الفيلم والسيناريو جيدين جداً- ولكن لم يمكن لأحد أن يضمن تنفيذ الفيلم في السودان دون تدخّل من النظام الإسلامي، خاصة في ضوء الثورة وكل ما جرى. كان التمويل الأول الذي حصلنا عليه لـ"وداعاً جوليا" من آفاق، وهذا شجّع الجهات الأخرى على دعمنا. كنا قد بنينا أيضاً مصداقية وسمعة بحلول ذلك الوقت، سواء كانت لي، أو لشركة الإنتاج -ستيشن فيلمز- أو للسينما السودانية بشكل عام.
ما سأقوله لصنّاع الأفلام السودانيين هو أن يصمدوا، رغم ما يعتريهم من يأس الآن، حيث كان لدى العديد منهم شركات وأعمال في السودان. كان لديهم عملاء مع منظمات غير حكومية أو معلنين على التلفزيون، وما إلى ذلك. كانوا يعملون، والآن هم نازحون إلى بلدان لا تحتاج إلى شخص قادم من السودان لإخراج إعلان أو فيلم. لذا يحتاجون الآن إلى العمل بشكل مختلف. يحتاجون إلى معرفة كيفية التقديم لآفاق أو لجهات تمويل أخرى يمكن أن تدعمهم، لأن هذا هو السبيل الوحيد. لم يكن هناك حكومة لدعمهم حتى قبل الحرب، لذا الوضع لا يزال كما هو، ولكن على الأقل كانت لديهم مواقع وفرق عمل. كانت لديهم عائلات تدعمهم إذا أرادوا بعضاً من الأمان. الآن الجميع نازح أو خارج البلاد. أبدو مستاءً، ولكن هذا هو الواقع.
قبيسي: في ظل الحرب، كيف تتصوّر الخطوات القادمة؟ كيف يمكن للسينما السودانية المضي قدماً؟
أبو العلا: لا توجد صناعة سينما في السودان، ولكن على الأقل بدأنا في تأسيسها. والآن نبحث عن بدائل. أعمل بالفعل على أربعة أفلام، واحد منها من إخراجي، وأنتج ثلاثة آخرين لمخرجين سودانيين. حتى قبل الحرب، كان مخططاً لهذه الأفلام أن تصوّر خارج السودان. الفيلم الأول يتحدث عن طفولة المخرج في مكة. المخرج الثاني يعيش في باريس، فهو فيلم سوداني في باريس. دعم هذه الأفلام الأربعة والتأكّد من استمرار حركة السينما السودانية التي بدأت عام 2019 أصبح الشيء الوحيد الذي يمكنني تقديمه من أجل الصناعة.
* ”ستموت في العشرين" فيلم أخرجه أمجد أبو العلا في 2019، وحاز على إشادة واسعة من النقّاد وحصل على العديد من الجوائز والترشيحات في المهرجانات وحفلات توزيع الجوائز الدولية.